المواضيع الأكثر قراءة
- شروط اعتقال محسنة للمخربين اليهود
- الشمس لن تغيب بين غزة ورفح
- أستاذ قانون دستوري: الهيئة المستقلة للانتخاب يجب أن تحدد موعد الانتخابات النيابية خلال 10 أيام
- الهيئة المستقلة للانتخاب: الأحزاب ستنضج أكثر
- النتائج النهائية لانتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم
- الملك يؤكد لنائب رئيس الوزراء الإيرلندي ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة
- حزبيون : الاستحقاق الانتخابي عنوان قوة الدولة
- تصعيد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية تضامنا مع غزة.. اعتصامات وإضراب واعتقالات
- حيدر محمود: إلى صاحب الوصاية من القدس: الأقصى والقيامة وما حولَهُما!!
- أكسيوس: قطر سلمت تسجيل الأسير غولدبيرغ لواشنطن قبل بثه
مريد البرغوثي فـــي أروع مـا نظــــم
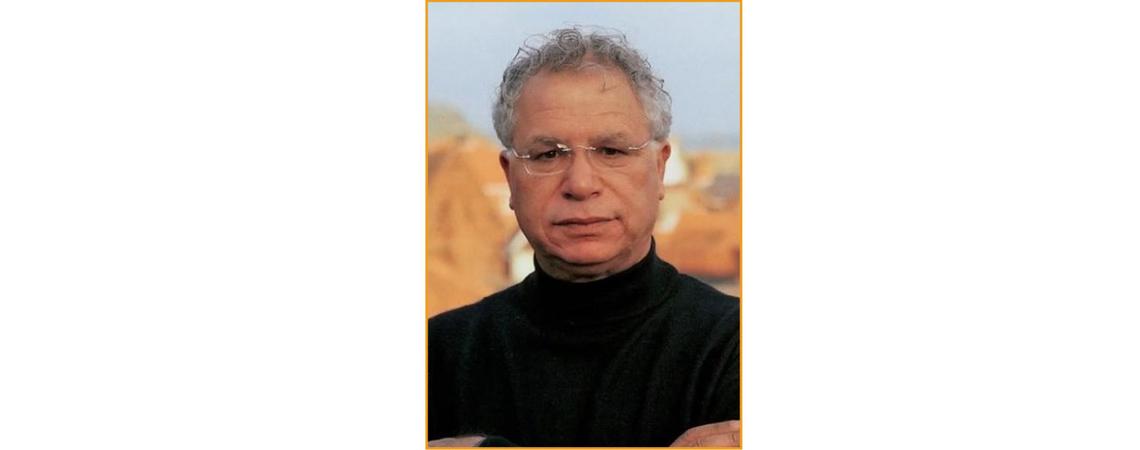
الدستور-د. إبراهيم خليل
هذا العنوان ليس ابتكارا، ولكنه محاكاة لعنوان آخر تخيره الأديب الراحل محمد صبري لكتابه الذي صدر في زمن مبكر جدًا (القاهرة: 1940) عن خليل مطران شاعر القطرين، وكان بعنوان خليل مطران في أروع ما كتب. والكتابُ المذكور يضمُّ مقالات خليل مطران، وخواطرهُ، عن الشعر والأدب، ولهذا رأينا أن نستبدل كلمة (نَظَم) بكتَبَ، لأنّ مقالنا عن البرغوثي يتصل بشعره، لا بنثره. ولو أنَّ الكلمة كتَبَ لا تبتعد كثيرًا عن نظمَ في المدلول وَفْق السياق الذي يضعنا فيه هذا المقال. فالكتابة تشمل الشعر، والنثر، والنظمُ أيضًا يشمل النثر مثلما يشملُ الشعر. بدليل ما نجده عند عبد القاهر الجرجاني (471هـ) من أحاديث عن النظم، فيما تكون أمثلته في الغالب، والأعمّ، والأرجح، من آي القرآن المجيد، إلى جانب الشعر المنظوم، والكلم المُبين على العُموم.
والذي نعنيه بهذا التعبير «أروع ما نظم» تلك القصائد التي اختارها بنفسه حين طَلب منه بعض أصدقائه في وزارة الثقافة برام الله أن يقدم كتابا لنشره في إصداراتهم، لا سيما وأن البرغوثي كان قد غادر البلاد للقاهرة للدراسة قبل عدوان 1967 ولم بعد إليها إلا في تلك الزيارة عام 1996 ولم يكن شعره متداولا في فلسطين إلا قليلا. وجاء اختياره لهذه القصائد من دواوينه دليلا على إيثاره لها على غيرها، وتفضيلها على سواها من قصائده. وعددها يقارب الأربعين، منها ما هو من شعره المبكر، ومنها ما هو من متأخِّر شعره. كقصيدة الشهوات، ورنين الإبرة، وصندوق جدتي، وقصيدته «رضوى.» ومنها قصائد أقدمُ، كقصيدة في رثاء أبيه (أبو منيف) وهي من قصائده المؤثرة التي تفْضُل الكثير من المراثي. ففيها رؤية جديدة لما ينبغي أن تكون عليه المرثية من حيث ضرورةُ الربط بين الخاصّ، وهو موقف الشاعر من وفاة أبيه، والعامّ، وهو موقف الفلسطيني من الموت، والنَفْي، فقد بوغت بخبر النعي، فكان حاله كحال المتنبي فزعًا بآماله للكذب، إذ كان يعتقد أن هذا الكون لا يكون كونا إلا بوجود أبيه الذي لم يتوقع له نهاية كهذه:
أدركتُه
وكأنه مذ كان لم يفجع بمخلوق سواك
الموت فينا منذ آدم يا أبي
عَمَمٌ ، وعاديٌ تماما
كيف باغتني إذن حتى العظام؟
فهو رثاءٌ ليس كالذي نعرفه مما ينظمه الشعارير، بل هو رثاءٌ يتعمَّق في سبر غور اللحظة التي يحس فيها الشاعر بالفجيعة، وبمرارة الفقد. وفيها تأملاتٌ تضارع في بعدها الإنساني عن الفج والسطحي تأملات شيخ المعرَّة. فهو يتعجب من سذاجته التي صورت له - كأي ابن - أن والده لن يموت. ولم يخطر له هذا ببال، فالكون بني على أساس أن والده فيه. وأن حياته شرط لازم لبقاء هذا الكون. وقد بدا للشاعر في القصيدة أن صوت النعي يحاول المستحيل لإقناع الشاعر بما كان:
وكأنما الناعي يحاول مستحيلا
مثل تحميل الحديد على الغَمام
كان يمكن لحنان هذا المتوفى، ولحُبِّ الآخرين له، أن يكونا عذرًا لملاك الموت، وسببا كافيا لتأخير أجله. فما أصعب أن يموت الأب فيما الأبناءُ، والأحفادُ، جميعًا متفرقون في المنافي، فلا يحظى الراحل في مثل هذه الحال لا بالعزاء الجميل، ولا بنظرة الوداع الأخير:
فاذهب وحيدًا يا أبي
واترك لنا هذي العجائب والخلائط
لا تقلْ شيئا
فإنَّ الموتَ في المنفى اتهام
وفي المختارات قصائد أخرى تعود بنا إلى دواوينه: قصائد رصيف، وعندما نلتقي، و ليلة مجنونة، ومنطق الكائنات، وغيرها.. وإحدى هذه القصائد بعنوان مشْهد يومي. وهي قصيدة تذكرنا بالفتاة التي لا تختبئ خلف المتراس*، بل تعلن عن وجودها برفع العلم الفلسطيني في شيء من التحدي، وذلك في إشارة واضحة لانتفاضة الشعب. فالقصيدة مؤرَّخة في 15/ 3/ 1988 أي في ذروة الانطلاقة الأولى لانتفاضة غزة أواخر العام 1987. ففيها تطرد صور شعرية هي التقاط لمواقف من الحياة اليومية قبل أن يفاجئنا المتكلم بصورة مبتكرة تجمع بين الحياة والموت جمْعًا مغايرا لما هو سائد:
يستمر المشهد اليومي
أولادٌ يعدون المقاليعَ
وأصواتُ هتافاتٍ وراياتٌ
وعسكرْ
يطلقون الناز في زهْو وفوضى
وصبيٌ آخرٌ يهوي شهيدا
فوق إسفلت الطريق
فبين زهو الجنود، وسقوط الصبي شهيدًا، مفارقة تعبر بالتناقض عن سريالية المشهد اليومي في الأرض المحتلة. وفي قصيدة قصيرة أخرى نجد صورة الإنسان الذي يعاني كثيرا من وفرة القيود وكثرة السلاسل التي تكبل هذا الكائن، وتجعله يجأر بالسؤال إلى متى؟ فلو كان يمتلك يدًا بحجم التلال، وكتفا بحجم الجبال، وعينا بألف عين، وخطوة بمسافة تربو على الألف ميل، فإنه لن يقوى على التخلص، والتحرر، مما يحيط به من قيود. شيء واحد هو الذي يخلصنا من ذلك ، إنه الموت:
لكننا
كما ترون – هكذا-
فالموت وحْدَهُ سيُسقط القيود
أو يوقظ السؤال
وفي أخرى قصيرة بعنوان «زقاق» صورةٌ لهذا الظلام المخيم على وجودنا وعلى حياتنا ولا يدع لنا بصيصا من أمل يومض ولو في نهاية النفق. ومع أننا نسعى متعمدين للظهور بمظهر المتفائلين، ونفعل ذلك بوسائل شتى منها الشعارات البراقة الرنانة، والأغاني الثورية، والأناشيد التي تنتشر بحجم السماء، والأسلحة التي لا تفتأ تطلق أعيرتها في الهواء، على الرغم من ذلك كله يدعو الشاعر للاحتفاظ بالقليل المتبقي، فالليل باق فينا طويلا، ولا يعتزم الجلاء:
يا عمرنا امتدّ
ويا أهل أطفالنا
أعدّوا لهم ما استطعتم من الضوء
أبقوا لهم كلَّ عود ثقاب
وخلوا القناديل ، والزيتَ
فالليل ينوي الإقامة فينا طويلا
فالبرغوثي، بكلمات قليلة جدا، عبر عن حالة البَوار الذي نعيشه، والخواء الذي يمسك بخناقنا ، ولا يبدو أنه عازم على الرحيل في المدى القريب. فهل نستطيع أن ندعي تشاؤم الشاعر، بالطبع نحن نحس ونشعر بهذا الألم الذي تعبر عنه القصيدة، وهذه الرؤيا اليائسة، المحبطة، لكن القصائد لكلّ واحدة منها أجواؤها النفسية، والوجدانية، ففي قصيدة «ورْدة» يصف المتكلم غارة شعواء لطائرات العدو على مواقع قد تكون قرى، وقد تكون مدنا، أو قواعد لفدائيين، فتقصف قصفا عشوائيا شديدا يخلف دمارا ويخلف جثثا هامدة، وتخلف خرابا ودمارا لا في الديار حسب، بل في المحبين، وفي الطيور، والأغنام المنتشرة على التلال، ولكن:
في ركام المشهد الموغل بالصمت
وفي الريح التي تصفرُ من حين لحين
فاجأتنا
وردةٌ منْفردَة
فعلى الرغم من كل ما ذكر من تدمير، وتخريب، وإبادة، ومن قتل بواسطة الطائرات، إلا أن الحياة مع ذلك تصرُّ على التجدد، والبقاء، وتتأبّى على الاجتثاث، والاقتلاع؛ فالوردة انبثقت من وسط الرماد والموت، ومقابل كل جثة مبتردة ثمة جمرة متقدة، ومقابل كل روح تزهق ثمة روح جديدة تخلق، فتنبثق من العدم انبثاق هذه الوردة.
ويسخر البرغوثي من ثوار لا يعرفون من النضال سوى التشدق بالشعارات، والتبجح بالألفاظ. فالمتكلم يعرض على أصدقائه في قصيدة (سهرة) أن يستحضر شهيدًا بما عليه من جراح، ودم متخثر، ومن ارتجاج، ثم يقوم بإسناده لينظروا إليه ويتعرفوا على مَنْ هو. يقول متسائلا: قد يقدرون، أو لا يقدرون على التحديق بذلك الشهيد، لكنَّ الشيء الثابتَ المؤكدَ أنهم :
وأعلم يا إخوتي
أنكم تجرؤون
وتستكملون التزيُّنَ للسَهْرة التالية
فهولاء الثوار في رأي الشاعر لا يحفلون بالشهداء الرفاق بقدر ما يحفلون بإعداد المقبلات للسهرة التي تلي السهرة. وكأن أمر هذا الشهيد، أو غيره- وهو منهم - لا يعنيهم في قليل أو كثير. ومن القصائد التي بلا ريب تشد القارئ شدًا قصيدة « الخنزير». وقد تبدو من النظرة الأولى وصفا لهذا الحيوان بملامح مقززة. بيد أن القارئ سيُلاحظ على الرغم من قصرها اختلاط صفات الخنزير الدبق بالإنسان، فهو لا يفتأ يذكر احتساءه القهوة، واختياره حذاءً لامعًا يرتديه، وقميصا منقوشا بخطوط، و ربطة عنق مشجَّرة، وبذلة فاخرة. وهكذا يقترب بنا الشاعر من لحظة المفارقة، فإذا بهذا الخنزير يملأ جيوبه وحقيبة السمسونايت بالنقود والعقود وعناوين العشيقات، ولذا يستحق أن يوصف بيته بالحظيرة.
يرتدي بدلته.. ثم يحشو
جيبه والسمسونايت
بنقود وعقود وعناوين العشيقات
ويلقي نظرةً بين المرايا
يسكب العطر على كفيه والخدين
مراتٍ ويمْضي
مغلقا باب الحظيرة
وفي قصيدة (مشورة) صورة أخرى لنموذج هو مسؤول كبير، رئيس أو من هو في مقام الرئيس، كانت قد قالت له عرافة أعجمية: إنه سيموت إن لم يستشر أحدا. لذا جمع علية القوم، وخاطبهم قائلا: إنه لن يستبدَّ بعد اليوم، ولن يتخذ قرارا دون الرجوع إليهم مستشيرا. وعلى الرغم من أن المستشارين شكوا في مزاعم هذا الرئيس، وفي الذي يقوله سيدهم الصنم، فقد رأوه:
يستل مرآةً ، ويرفعها، وينظر
ثم يسألها
فتنطق بالمشورة
ثم يشكرها ويكسرها
مخافة أن يعوِّدها على حقّ الكلام
ومما يلفت النظرَ في هذه المختارات قصيدة بعنوان (غمْزَة) واللافت فيها أن الشاب موضوع القصيدة يشارك شبانا الدبكة في أحد الأعراس، وتلوح له صبية معجبة بطريقته في الدبكة، لا سيما وأنه قائد الفريق الذي يسمى عادة (اللويح) فتغمزه الفتاة بإحدى عينيها غمْزَة تبعث في نفسه الجنون، ويتجلى ذلك الجنون في عنفوان الدبكة والتلويح:
غمزة من عينها في العرسِ
وانْجنّ الولدْ
وهذا الجنونُ يصرف نظر الشاب عن كل ما عدا الفتاة، فالأهل من عمات، وخالات، ومن شبيبة، ومن مخاتير، ومن رجالات تلتصق أكتاف بعضهم ببعض في الحلقة مستعيذين من الحزن، كأنهم غير موجودين، أو كما يقول إبراهيم ناجي « هذا الزحام لا أحد « فالبنت التي خصته بتلك الغمزة أصبحت - مثلما يقول الشاعر- كل البلد:
وحده اللويح ،
في منديله يرتجُّ كل الليل،
والبنت التي خصته بالضوء المُصفى
أصبحت كل البلد
وعلى هذا المنوال، وفي هذا النسق، يواصل البرغوثي تنضيد الصور المبتكرة التي تجسد رؤياه لهذا الشاب اللويح، وهو يرفع قدما تارة، وتارة يثبتها على الأرض، كأن الذي يتحرك في كيانه جان لا إنسان، وكلما أخذ منه التعب مأخذا جدد النايُ نشاطه فاستأنف التلويح مرَّة أخرى، لا يبالي بالعرق الذي ابتل منه القميض الأبيض، وابتل منه الصدر، والحزام الجلد، والظهر، حتى فقراته أضحت تحصى بالعدد من شدة التعرُّق، ولسان حال هذا الشاب يقول:
غمزة أخرى ولو متّ هنا
غمزة أخرى ولو طال انتظاري
للأبد.
وأحسبُ أن هذه الفصيدة من أكثر القصائد ندْرَةً لا من حيث الموضوع، بل أيضا من حيث البناء الفني، والتشكيل الشعري، الذي تلاعب فيه البرغوثي بالألفاظ جاعلا منها شيئا يشبه سحر النغم حين يهبمن على المتلقي:
قدم ثبتها في الأرض لمْحًا
ورمى الأخرى إلى الأعلى كشاكوش
وارساها وتدْ
كلما أوشك أن يهوي على سَحْجةِ كفٍّ
جاءَهُ من صَحْوة الناي سندْ
ومع صعوبة هذا الموضوع، وطرافته، وجدته، فقد طوع الشاعر الألفاظ لهذا الغرض، وأطلق لنفسه حرية الاختيار، مستخدما كلمة (انجنّ) الدارجة فجاءت في هذا الموضع أكثر جمالا من الفصحى (جُنّ) وكذلك استخدم كلمة شاكوش، والولد، وغيرها مما يعطي الانطباع عن امتلاك الشاعر القوي لأدواته، هذا عدا عن الإيقاع الناشئ عن وزن الرمل، وتعاقب الروي الوقفي الانفجاري بما فيه من شدة تناسب خبط الدبيكة الأرض بأقدامهم خبطا شديدًا على وقع الناي، كل ذلك أشاع في القصيدة جوًا من الانسجام، والتفاعل الداخلي، الذي لا نجده في الكثير من الشعر الركيك الذي يملأ الصحف، والدواوين. وإذا أضفنا لما سبق قصائده: رنين الإبرة، وصندوق جدتي، ورضوى، ثبَتَ لنا أنّ هذه المختارات من أرْوع ما نظمَهُ البرغوثي.
*انظر مقالنا في القدس العربي 22/ 3 /2021


