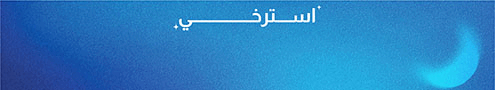المواضيع الأكثر قراءة
- كتل نيابية تستهجن الادعاءات الكاذبة وتشيد بموقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية
- الأردن لحوار السياسات: نوايا خبيثة وأجندات سياسية مشبوهة، ليس جديدًا على من ضاقت صدورهم بثبات الأردن
- الملك يهنئ قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه
- مسلمون حول العالم: لم ندفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية
- لجان المخيمات الفلسطينية تستنكر محاولة التشكيك بدور الأردن
- ٢٧ شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة
- أورنج الأردن توقع اتفاقية توريد أجهزة حاسوبية لجامعة العلوم التطبيقية لاستدامة تحديث المختبرات المركزية
- لدينا جميعُا أسرار ....، لكن ما الأثر إن احتفظنا بها لأنفسنا؟
- الحبل الذي قد يشنق نتنياهو.. لماذا قطع ترامب الاتصالات؟إيهاب جبارين
- الأمير علي: ماضون في عملية إنشاء ملعب دولي
الأسواني الذي قرع الجرس
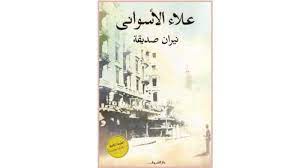
الدستور-إبراهيم خليل
في العام 1989 كتب علاء الأسواني رواية قصيرة سماها «أوراق عصام عبد العاطي»، ولهذه الرواية حكاية بدأت حين دفع بها للهيئة العامة للكتاب. فرد عليه أحد المكلفين بتقويم المخطوطات المقدمة للنشر قائلا: مستحيل أنشر هذه الرواية؛ لأنك تشتم فيها مصر، وتسخر من مصطفى كامل الزعيم الوطني.
وعندما رد الأسواني على هذا الموظف، الذي لا دراية له بالرواية، ولا بالأدب عامة، مؤكدًا أن هذا هو موقف بطل الرواية، لا موقفي. وبعد جدل استمر دقائق طلب منه هذا الموظف أن يكتب استنكارًا يندِّد فيه بآراء البطل الروائي، ويتبرأ مما جاء على لسانه بشأن مصر والمصريين، وبشأن الزعيم الوطني. لكن الرواية، على الرغم من ذلك الاستنكار، لم تُنشر. وعندما تساءل عن السبب، وجد موظفا آخر كسابقه لا دراية له بالرواية، ولا بالأدب، فاشترط عليه هذا حذف الفصلين الأولين. فذكــّـره الأسواني بالاستنكار الذي كتبه، ووقعه بناءً على طلب الموظف السابق، فما كان من هذا الموظف إلا أن مزق الاستنكار، قائلا: لن تُنشر هذه الرواية إلا بعد حذف الفصلين: الأول، والثاني.
الوجه والمرآة:
وقام المؤلف، بعد يأس، بنشر الرواية على نفقته الخاصّة، ووزع النسخ على الأصدقاء والنقاد. ثم كرت الأيام والسنون واشتهرت رواياته: عمارة يعقوبيان، وشيكاغو .. وغيرهما. فاندفعت دورُ النشر تبحث على عادتها عن أيّ عمل آخر له لم يُنشر لنشره، فكان أن نُشرت هذه الرواية مجدَّدا، وأعيد نشرُها مع قصص قصيرة في كتاب بعنوان « نيرانٌ صديقة « وهو عنوان يشير إلى ما في الرواية، والقصص، من جرأةٍ، وصراحة، غير معهودة، تسلّطُ الضوء على ما ينبغي أن نراه حين ننظر إلى وجوهنا في المرآة. فالسارد- عصام عبد العاطي - ينظر في المرآة قبيل توجهه إلى المركز الثقافي الألماني الذي يقع في شارع صاخب من شوارع القاهرة لحضور افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي. فيقول، وقد تذكر أباه، ووجه أمه، وكلَّ من عرف ؛عم أنور، ومحمد عرفان، الماركسي القديم، و الغامدي مدرس اللغة العربية، ود. سعيد في مصلحة الكيمياء، وأم عماد، وسائر الموظفين، والخادمة هدى (أم كوثر) تذكر هؤلاء متقززا، فاسرع كما يقول ليكتب في أوراقه « نحن الجديرون بالعذاب لأننا مشوهون» فهذا الساردُ وقع أسيرًا لروح الغربيين من أوروبيين، وأمريكيين، متسائلا: هل صحيح أن الله سيعذب هؤلاء ويزجُّ بهم في الجحيم؟ ويجيب عن هذا دائما: لا أتوقع. فنحن الذين نستحق العذابَ، والجحيمَ، لا هم.
فنان كاريكاتير:
تبدأ حكاية عصام عبد العاطي بعبارة يتذكَّرها، وهي عبارة مصطفى كامل « لو لم أكن مصريًا لودَدْت أن أكون «. فهو يردّد هذه العبارة ساخرًا، فما الذي يدعو مصطفى كامل – لو كان عاقلا- لهذا، والحال أنّ مصرَ لا شيءَ فيها يدعو لهذا التعصُّب؟ ها هو يذكُر لنا في حكايته ما جرى لمحمود عبد العاطي – أبيه – كيف تُرك ليموت دون أن يبكيه أحد، إلا من صديق لقي ما لقيه هو من نُكران. وهذا مثال واحد فحسب. أحبَّ الرسم منذ الصغر ، وعندما غادر الزقازيق للقاهرة، وهو ابن أربعة وعشرين، أقام معرضه الأول للوحات الزيتية. (ص31) ونجح في أن يكون رسام الكاريكاتير في ثلاثٍ من الصحف. لكن محمودًا هذا ينقصه – مثلما يعتقد ابنه الوحيد عاصم- اللمعان(ص32) فبعض الناس يولدون وهم محاطون بهالةٍ من اللمعان. وهذا شيءٌ يذكّرُ السارد بمقارنة بسيطة جدا. فاكتشاف العالم الجديد يُعزى لكولمبوس، صاحب هذه الهالة من اللمعان، في حين أنّ شريكه الذي أشار إلى الطريق الصحيح نحو الأمركيتين، أمريكو فسبوتشي، نسيه التاريخ، إذ لم تكن لديه مثل تلك الهالة من اللمعان. (ص33) وهذا ما ينسحب على كثير من الموهوبين. ووالده أحد هؤلاء، فقد وُلد، وعاش، وتوفي، مفتقرا لتلك الهالة. وهذا ما يفتقر له عم أنور، الذي كان يأمل أن يصبح ملحنا مشهورًا كزكريا أحمد، أو رياض السمباطي، وافتقاره لهذا اللمعان جعله يكتفي بموقع ملحّن صغير في فرقة الراقصة الخليعة (سُكّر). ولهذا لا لوْم على أنور، أو الغامدي، أو محمد عرفان، في أن يلتقوا في مرسم عبد العاطي، ويتعاطوا الحشيش، ويحتسوا الخمر، لأنهم بهذا يهربون من الواقع الذي يحاصرهم حصارًا شديدًا.
تغيير الماجريات:
تتوقف قدرة الكاتب الروائي على تطوير السرد توقفا مرتبطا بالحوافز التي تدعو لتغيير مسارات النص. ومن هذا الباب بادر المؤلف لحافز جديد، ولتحول ناتج عن تسلُّم محمود عبد العاطي خطاب إعجاب من مدرس رسم من الدقهلية اسمه محمود علي فرغلي. يعرب هذا المدرس، وهو فنان مبتدئ ،عن إعجابه الشديد بأعمال عبد العاطي، مؤكدا أنه زار معرضه الأول في القاهرة، وأنه جاء للقاهرة من الدقهلية لهذا الغرض. وأنه سعيد بأن يكون تلميذه الذي يسير على خطى أستاذه خطوة تلوَ الأخرى (ص40).
لهذا الخطاب تأثير كتأثير الحجر يلقى في المستنقع. فقد تضرج وجه محمود عبد العاطي بالسعادة الغامرة والفرح البالغ. واتخذ من الخطاب دليلا ساطعا، وبرهانا قاطعا، على أن الفن في مصر ما يزال يحتفظ بجمهوره(ص40- 41) لكنَّ كلا من أنور – الموسيقي- و الغامدي- مدرس العربية- لا يوافقان على هذا الاستنتاج، بل يصران إصرارًا على أن الفن في مصر بات بضاعة كاسدة، فلا تقدير له، ولا جمهور، ولا ما يحزنون « عاوز تقنعنا بأنه يوجد في مصر جمهور للفن. انزل الشارع.. وانت تفهم «(ص43).
وازداد التوتر حين اكتشف الجميع أن عصامًا مزَّق الخطاب، وتطايرت فتافيته تطايرَ أوراق الشجر في الخريف.
شهقة الموسيقي:
في موازاة هذه المناكفات التحق عصام بكلية العلوم تخصص كيمياء. وابتاع من أحد أكشاك الصحف عدد «الحياة» وهي المجلة التي يواصل منها الفنان عبد العاطي مخاطبة جمهوره. وجد على الغلاف كاريكاتيرًا لوالده، ورآه بعض الطلاب، وتجادلوا فيه، وخاضوا. وعند عودته للمنزل اقترب من والده، وأشار للرسم، قائلا: نكتتك اللي رسمتها النهار ده كانت حَ تودينا القِسْم « (ص50). فقد قيل إن الوجه يشبه وجه السادات. عندما أصيب والدهُ بجلطة في المخ لم يزره في المستشفى إلا عم أنور الذي داعبه ساخرًا: « جرى أيه يا سي عبده. دي حركة تعملها.. دي .. « ولكن هذا الذي يقول ما يقوله ساخرًا، ضاحكا، لم يستطع حبْس دموعه « انحنى للأمام، ووضع يديه على وجهه، وعلا شهيقهُ ببُكاءٍ عنيف. « (ص55)
بعد وفاة محمود عبد العاطي، وتخرج عصام، إزداد إيقاع الحوادث سرعة، فقد عُيِّن عصام في مصلحة الكيمياء التي تقع في شارع رمسيس(ص56) وتجري له في هذه الدائرة وقائع تشحنُ الرواية بغير قليل من التوتر الذي يشد القارئ شدًا. يتربع على كرسي الإدارة فيها شخص يلقب بالدكتور مع أنه رسب في الدكتوراه مرارًا. يرسم السارد لهذا الدكتور(سعيد) صورة كاريكاتيرية هي النموذج الشائع بين المديرين الذين يتمتعون برضا الهيئة الحاكمة. شخص لا يهتم إلا بالطعام، ومتابعة أخبار الكرة، والأندية المتنافسة؛ من زمالك، وأهلي، والسيارات، والجنس(ص56). وموبقاته في هذا الشأن الأخير معروفةٌ، مشهورة، تكاد لا تخفى على أحد. وفي هذه الأجواء الموبوءة شعر عصام شعورَ منْ يوقن أنه خُلق منْ معدن لم يُخلق منه الآخرون في الدائرة. فعندما دعاه د. سعيد لزيارته في المكتب، نهرهُ قائلا» أنا ما عنديش وقت أتسلى «. (ص61)
للتحقيق فورًا:
ومن مظاهر التفوّق الفنّي لدى الكاتب الأسواني تخير اللحظات الحرجة لإجراء تحول ما في السرد. ففي بدء شهر رمضان يتفجر الموقف في مصلحة الكيمياء لأن عصاما أراد من الفراش عبد العليم أن يحضر له قهوة. وهذا الفراش هو أحد عيون الدكتور سعيد، وجواسيسه. فاعتذر له بسبب حرمة الشهر، ووشى به لدى سعيد بيك، الذي وضع لافتة توجبُ الامتناع عن أي تصرف يخدُش حرمة الشهر. وأما عصام، فقد تحدى ذلك، وأحضر معه من البيت سخانَ قهوة(تيرموس). ويبدو أن الدكتور سعيد وجدها فرصة لافتعال مشاجرة، فقام بجولة على المكاتب ليجد رائحة الدخان تنتشر في مكتب عصام الذي يمسك بإحدى يديه كوبا من القهوة، وبالأخرى سيجارة. وكأنَّ رمضان لا يعنيه من قريب أو بعيد.. فصاح به مستنكرًا: يا أخي، إذا بُليْتُم فاستتروا. هو أنتَ مش مسلم.. ولا أيه؟
وانتهت المشادَّة التي التمّ فيها الموظفون بزعيق المدير: ده شيوعي. شيوعي.. يا ناسّ!! قلبي كان حاسِسْ من الأوَّل. حوّلوه للتحقيق فورًا. (ص66)
أم عصام والسرطان:
في الأثناء تظهر بوادر ورم خبيث لدى الأم في الصدر، وفي البدء تتجاهل الأمر، لكن الورم يتسع، ويمتد إلى مساحات أكبر، ويبلغ العنق. وعيادة الطبيب في المساء مزدحمة بالمرضى (ص68). وفي هذه الأحوال المستجدة تبدو الفرصة مناسبة للإعلان عن ظهور شخصية جديدة (عبّاس) خال عصام، الذي عمل في الخليج مدة، وبين الحين والآخر يدفع ببعض الجنيهات مساعدة لأم عصام خِفْية عن زوجته (حكمت) التي لا ترضى عن زيارته لبيت شقيقته أم عصام، فكيفَ إذا علمت بما يقدمه لها من مساعدة؟ « حكمت كِبْرت، وبقَتْ خلُقية، وأنا مش ناقصني مشاكل « .
هكذا يقول كلما مدَّ إليها بظرفٍ فيه بعضُ الجنيهات (ص70) .
على أن عصامًا، ومن متابعته للأخبار، ولأفواج السياح الأوروبيين الذين يراقبهم بروح ملأى بالحسد على ما ينعمون به من بساطة في المأكل والمشرب والملبس، ومن محاسن تتجلى في زرقة الأعين، وبياض البشرة، والشعر الأشقر الناعم، التقط نبأ عن افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي في المركز الثقافي الألماني مثلما مرّ. وهناك سمع صوت أنثى تعلق على إحدى الصور قائلة: هذه الصورة تسيءُ لمصر.
ففي الصورة أطفالٌ حفاة بأسمال بالية، في مكان تنتشر فيه النفايات والقمامة. شُدِهَ عصام بالصوت أولا، ثم شُدِهَ أكثر بمرأى الفتاة، وما هي عليه من جمالٍ يأسر الألباب. رد عليها زاعمًا أن الصورة لا تسيء، فهذه هي حقيقة مصر، والمصريين، وهي حقيقةٌ تتمثل في تلك الصورة.
وطال الحديث بينهما كثيرًا. هي تدافع عن مصر والمصريين، وهو يذمهم ذما شديدا لما يتجلى في طباعهم من هوان. فهم لا يفهمون إلا لغة العصا(ص 87)وهي ترى فيهم أناسا موهوبين، وطيبين، ولديهم مشاعر لا تجدها لدى شعوب العالم (ص91). ودعاها لتناول كأسين في فندق سمير أميس. وتقبلت الدعوة قبولا مثيرًا للدهشة. وجرى التعارف بسرعة مذهلة، فهي يوتا، ألمانية تعمل في القاهرة من سنتين في شركة أستيراد وتصدير. تتحدث الإنكليزية بطلاقة. وعندما يقارن بينها وبين أمه والخادمة هدى (أم كوثر) يجد الفرق الشاسع فاصلا ما بين الجماعتين. علاوةً على أنّ سرعة التقارب بينهما نبهته لشيء مهم، وهو جرأته في التعامل معها جرأة لم يعهدها في نفسه. لعل شيئا ما وقع تحت سحره فجعله يتصدى لشعبان البقال المتديّن(ص95) حين استضافته في شقتها بشارع نصر. وقضى ليلة حمراء لا تُنسى بيد أن العلاقة لم تستمر، بل تأكد أنها مثل زهرة التيوليب Tulip جميلة، لكن قصيرة العمر.
اختفاءٌ يُسفر عن تحولات:
عندما افترقا صباحا، اتفقا على لقاء بعد الثالثة في مكتب الشركة الذي كتب عنوانه على ورقة احتفظ بها في جيبه. وفي الموعد غادر المنزل غير مبالٍ بتوسلات أمه المريضة التي تحتاج للمساعدة. فصُدمَ بعدم وجود موظفة في الشركة بهذا الاسم. وعندما أصرّ على مقابلة يوتا، وارتفع صوته، فوجئ بيسري مصطفى صاحب الشركة ببذلته الرمادية يندفع نحوه، ويمسك به، ثم يدفعه بقوة، ويلقي به خارج المكاتب. وتوجَّه إلى المنزل الذي بات فيه ليلته السابقة مع يوتا في شارع نصر- عباس العقاد، ليَعْترض طريقه شعبان البقال، صائحًا « رايح فين يا أخ «؟
كانت المؤامرة محكمة، فقد تبين أنّ يوتا الألمانية لا هي يوتا، ولا ما يحزنون. و أن الشقة، لا هي منزل يوتا، ولا الشركة المذكورة في العنوان تعرف موظفة ألمانية بذلك الاسْم. في المحكمة أنكر الشهود وجود يوتا. والنادل في فندق سمير أميس أنكر وجودها، وادّعى أن عصامًا جاءَ وحيدًا، وأنه سمعه يتحدث لنفسه بالإنكليزية، وكانه يخاطب شخصًا آخر. وأنكر شعبان رؤيته قادمًا مع يوتا، مؤكدًا أنه رآه يدخل العمارةَ وحيدًا، ولذا اكتفى برد التحية، ولم يفتعل أي مشاجرة معه.
يكتشف عاصم- في نهاية الأمر- أنه مختلفٌ اختلافا شديدًا عن سائر المصريين، ولهذا تآمروا عليه، وأوحوا للآخرين أنه في حاجة لعلاج نَفسي، فمن لا يُذعنُ لخطاب السلطة، إنسانٌ غير سوي على الأرجح. وربما كان الفارق بينه وبين الجنون أقل بكثير من الفارق بينه وبين العقلاء.
براعة في التأليف:
ما يسْترْعي الانتباه هو قدرة الكاتب على نسج حكاية تتضمن سلسلة مترابطة من المتواليات البعيدة عن التشتت. وتخلو في الوقت نفسه من المفاجأة التي تجعل من حادثةٍ واحدةٍ ما، أو موقف واحد، مفتقرًا للسبب الذي يسلط المؤلف عليه الضوء. فالتالي من الأحداث ناتج عن المتقدم، والسابق من الوقائع يمهد للاحق، ويوطئ لما تسفر عنه المجريات. ومما يجلو هذا الانطباع، ويظهره، ندرة الشخوص. فالكاتب يركز تركيزًا لافتًا على محمود، وعصام عبد العاطي، وقليلا على سعيد، وأنور، والوهمية يوتا. وكلها شخصياتٌ تقتصر أدوارُها الثانوية على مساعدة أحد الشخوص، أو إعاقة مساعيه. وتبعًا لذلك، يشعرُ القارئ – كالدارس- بخيوط غامضة، وخفيّة، تشدُّه إلى هذه الشخوص، فلا تفارقُ الذهن إلا بعد أن ينتهي من قراءة الرواية، ولا سيما العبارة الأخيرة التي يزْعُمُ فيه السارد أن هذه الأوراق نسخة طبق الأصل تمامًا، فلا زيادةَ فيها، ولا نُقصان.