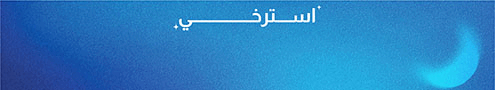المواضيع الأكثر قراءة
- كتل نيابية تستهجن الادعاءات الكاذبة وتشيد بموقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية
- الأردن لحوار السياسات: نوايا خبيثة وأجندات سياسية مشبوهة، ليس جديدًا على من ضاقت صدورهم بثبات الأردن
- الملك يهنئ قداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه
- مسلمون حول العالم: لم ندفع أي مبالغ للهيئة الخيرية الأردنية
- لجان المخيمات الفلسطينية تستنكر محاولة التشكيك بدور الأردن
- ٢٧ شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة
- أورنج الأردن توقع اتفاقية توريد أجهزة حاسوبية لجامعة العلوم التطبيقية لاستدامة تحديث المختبرات المركزية
- لدينا جميعُا أسرار ....، لكن ما الأثر إن احتفظنا بها لأنفسنا؟
- الحبل الذي قد يشنق نتنياهو.. لماذا قطع ترامب الاتصالات؟إيهاب جبارين
- الأمير علي: ماضون في عملية إنشاء ملعب دولي
المعلّقات بين المقدّس والمدنّس
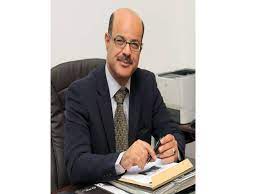
الدستور-غسان إسماعيل عبدالخالق
مما يُرثى له أن تردّد بعض المناهج التعليمية، فضلاً عن كثير من المدرّسين، مغالطة مفادها أنّ (المعلّقات) قد اكتسبت هذا المسمّى؛ لأنها كانت تعلّق على أستار الكعبة في العصر الجاهلي! مع أنّ الأدلة التاريخية والنقدية، الخارجية والداخلية، تنقض هذا الزعم جملة وتفصيلاً.
إذا شرعنا بإشهار الأدلّة التاريخية، فإنّ أول ما يقف لنا بالمرصاد حقيقة أنّ الإجماع على وجود مختارات شعرية في العصر الجاهلي – كائناً ما كان عددها- يتطلّب وجود إطار سياسي أو اقتصادي أو ثقافي جامع للعرب قبل الإسلام. ولسنا بحاجة للقطع بأنّ هذا الإطار لم يكن موجوداً في ذلك العصر، جرّاء واقع التشرذم الذي اقتضاه نمط الحياة البدوية الرعوية؛ بل إنّ هذا الواقع صبغ حياة العرب آنذاك بالتناحر الدائم الذي حال دون توفر الحد الأدنى للتوافق على أي جامع مشترك.
وثاني هذه الأدلة التاريخية، يتمثّل في حقيقة انتشار الأمّية على نطاق واسع بين عرب الجاهلية، إلى الحد الذي يستحيل معه تصوّر وجود صحائف شعرية مطوّلة ومعلّقة على أستار الكعبة، علماً بأنّ عدداً من الباحثين الموثوقين، عرباً وأجانب، شكّكوا في صحّة رواية كثير من أبيات هذه المختارات الشعرية المطوّلة! أي إنّ الرّواية الشفوية لهذه المختارات – وهي الوسيلة الوحيدة التي تكفّلت باستمرارها جرّاء تفشّي الأمّية - ما زال العديد من علامات الاستفهام يُحيط بها، فما بالك بعلامات الاستفهام التي يمكن أن تحيط بزعم من زعموا وجود رواية مكتوبة!
وثالث هذه الأدلة التاريخية الدامغة يتمثل في حقيقة أن سُوَر القرآن الكريم قد ظلّت مكتوبة في جلود وقراطيس وكواغد مفرّقة، ولم تُجمع في مصحف جامع – رغم قدسيّتها وجلالها- إلا في عهد الخليفة عثمان بن عفّان، رضي الله عنه، أي بعد نحو خمسة عشر عاماً من وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلّم. وأما بخصوص الحديث النبوي الشريف، فقد تطلّب الاقتناع بتدوينه – جرّاء الخشية البالغة من اختلاطه بالقرآن الكريم- أعواماً أكثر من ذلك بكثير. والشاهد المستخلص من هذا الدليل التاريخي الدامغ، يتمثّل في حقيقة الاعتماد على الرواية الشفوية المتواترة الموثّقة والتحرّز الشديد من التدوين الذي قد يعتوره بعض الأخطاء في النسخ بسبب سهو الناسخين أو تواضع علم بعضهم بما ينسخ. ولسنا بحاجة للتذكير في هذا السياق، بحقيقة أنّ الإجازة العلمية عند العرب بعد الإسلام، ظلّت منشدّة للرواية الشفوية والتتلمذ السّماعي المباشر على العلماء، إلى درجة أن من عُرف عنه الإكثار من الاعتماد على الصحف، ومهما علا كعبه في العلم، ظل موضع تحفّظ المعاصرين واللاحقين له، ولعل أبرز نموذجين اصطليا بنيران هذا التحفّظ هما: أبو فرج الأصفهاني في المشرق وابن حزم الأندلسي في المغرب.
وأما إذا انتقلنا لإشهار الأدلة النقدية الدامغة، فسوف تطالعنا أولاً المصداقية العلمية المجروحة لجامع هذه المختارات، وأعني به (حمّاد الرّاوية الكوفي ت156هـ) الذي قطع الأصمعي بأنّه كثير الكذب والتزيّد، هذا فضلاً عن مجونه ولهوه المشهور، ومنافسته لـ(خلف الأحمر البصري ت180هـ) الذي لم يقل عنه خلاعة وكذباً وتزيّداً. وللقارئ الكريم أن يتخيّل ما يمكن لهذه المنافسة أن تمدّه من حبال الاجتراء على التزيّد، وخاصة إذا اقترنت بعشرات الآلاف من الدنانير التي أُغدقت على الاثنين!
وأيّاً كان المدى الذي بلغه راوي المختارات على صعيد التهتك العلمي والأخلاقي، فإنّ هناك إجماعاً على أنّه اختار سبعاً من القصائد الطّوال وهي قصائد: (امرئ القيس وزهير وطرفة ولبيد وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلّزة وعنترة)، وظلّت كذلك حتى جاء أبو زيد القرشي الذي لا نكاد نعلم عنه شيئاً، سوى أنّه عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وأطلق على هذه القصائد السبع الطوال مسمّى (المعلّقات)، وجعلها الطبقة الأولى من طبقات كتابه المذهل (جمهرة أشعار العرب) الذي كان يمكن أن يكون المصدر الأول للشعر الجاهلي – نظراً لتماسكه المنهجي- لولا أنّه أخلى كتابه من الإسناد الذي جعل من (المفضليّات) ثم (الأصمعيات) المصدرين الرئيسين، على الرغم من كل ما يعانيانه على الصعيد المنهجي. ثم جاء ابن عبد ربه (ت 328هـ) فأدلى في كتابه (العقد الفريد) بتأويلٍ لتسمية أبي زيد القرشي، مفاده أنّ العرب أطلقت على هذه المختارات مسمّى (المعلّقات)؛ لأنها كانت تعلّق على أستار الكعبة مكتوبة بماء الذهب! مع أنّ القرشي الذي أطلق عليها هذا المسمّى لم يقل بذلك، ومع أنّ (المعلّقات) تعني لغوياً: النفائس والقلائد. وقد نفى أبرز شارحي المعلّقات - ابن النحّاس (ت 338هـ)- دعوى أن تكون قد سُمّيت كذلك لأنها كانت تعلّق على أستار الكعبة، وأكّد الدّلالة اللغوية المحضة للتسمية.
ولعل آخر وأنفذ سهم يمكن أن نسدّده، للإجهاز على قول من قال بأنّ القصائد السبع أو العشر الطوال المختارة، قد كانت تعلّق على أستار الكعبة، يتمثّل في استقراء مضمون معلّقة أمير شعراء العرب بلا منازع، وأعني به امرأ القيس؛ فهذه المعلّقة - فضلاً عن كل ما يحيط بروايتها من اختلاف وتنازع على صحة معظم أبياتها – تمور باللوحات الجنسية الصاخبة بحيث تستحيل معها، إمكانية تقبّل تعليقها على أستار الكعبة، التي لم تقل درجة تقديسها في العصر الجاهلي عن درجة تقديسها في الإسلام، على الرغم من وثنية العرب الجاهليين الذين أحاطوها بالأصنام! فكيف لسادة قريش أن يقبلوا تعليق قصيدة على أستار البيت العتيق، وقد سبق لقائلها أن عُوقب بالطرد من جانب أبيه لأنه قَبِل على نفسه قول الشعر أولاً، ولأنه استفاض في التشهير بابنة عمه ثانيًا، ولأنه استفاض أيضاً في تصوير مغامراته الجنسية مع غيرها على نحو صادم ومبتذل وسادي ثالثاً؟!